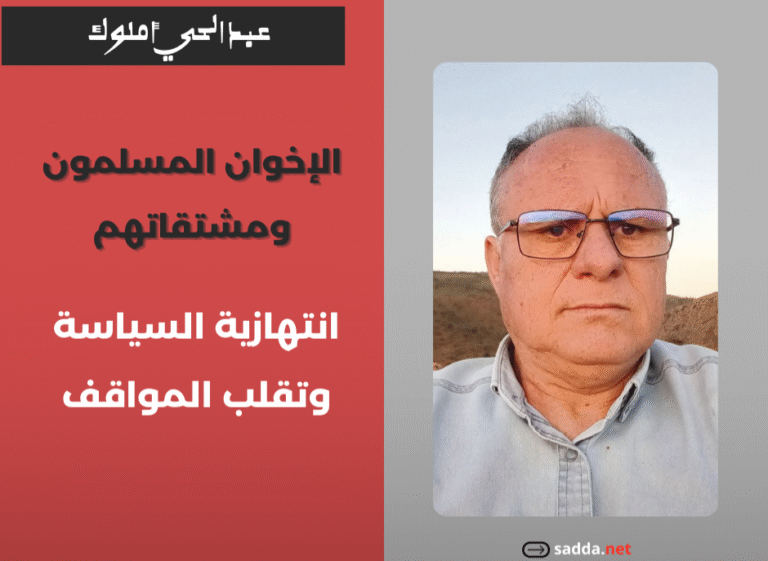هاجر الريسوني
في الوقت الذي يعيش فيه المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات، بسبب ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية وارتفاع الأسعار، ظهرت قبل أيام دعوات إلى النزول إلى الشارع يوم 27 سبتمبر، حيث تم إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف نفسها على أنها تمثل شباب جيل “زيد” باسم genz212.
هذا الجيل الذي يعيش بين العولمة الرقمية، الضغوط الاقتصادية، والأزمات السياسية، لكنه في الوقت نفسه الأكثر اتصالًا بواقعه وتحررًا من الأنماط التقليدية.
فمنذ سنوات يدور نقاش واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية حول قدرة جيل “زيد” والأجيال اللاحقة على كسر القيود وفتح مسارات جديدة للتغيير، في ظل السياق الصعب الذي يعيشه المغرب منذ ما يقارب عقدًا من الزمن.
فبعد الزخم الذي خلقته حركة 20 فبراير سنة 2011، وما أتاحتهُ من فسحة أمل وإحساس جماعي بقدرة المجتمع على الفعل والضغط، جاءت موجة القمع في السنوات اللاحقة لتعيد تشكيل المشهد. إذ اتسمت هذه الفترة بالاعتقالات السياسية، والمتابعات القضائية، وتقييد الحريات، وعودة المقاربة الأمنية كخيار مهيمن لمواجهة الاحتجاجات والحركات الاجتماعية.
وعلى خلاف الأجيال السابقة التي كانت تحركها الإيديولوجيات و القضايا الكبرى، ينظر إلى هذا الجيل بوصفه مختلفًا جذريًا عن الأجيال السابقة، سواء في طريقة تشكله أو في أساليب تعبيره عن نفسه. غير أنّ أبرز سماته التي تطرح للنقاش هي فردانيته، براغماتيته، وأحيانًا ما يوصف بغيابه عن المواقف؛ إذ يميل جيل “زد” إلى الحلول العملية المباشرة.
وفي أول خروج علني للمجموعة، بعد الهجوم الذي تعرضوا له من طرف صفحات تشهيرية وبعض المواقع القريبة من السلطة التي اتهمتهم بـ”الانفصال” والسعي إلى “التخريب” و”الانقلاب على الحكم”، أكدوا أنهم مع “الملكية باعتبارها ضامن استقرار المغرب ووحدته واستمراريته”، وأن مطالبهم تنحصر في “الإصلاح والتطوير داخل إطار الدولة ومؤسساتها، وضمان كرامة المواطن وعدالة اجتماعية حقيقية، مع جعل الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد”، معتبرين أن رسالتهم واضحة: “نضال سلمي، إصلاح حقيقي ومغرب أفضل للجميع”.
هذا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان بدايات حركة 20 فبراير، وإن كان السياق مختلفاً من حيث الظروف وحتى الجيل. غير أن الملاحظ أن هذه الحركة لا تأتي من فراغ، بل تنخرط في دينامية عالمية أوسع؛ فقبل أسابيع فقط، شهدت نيبال موجة احتجاجية قوية قادها جيل “زيد”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية مشابهة.
هذا التزامن يُبرز أن جيل “زيد”، سواء في المغرب أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا، يعيش الإحباطات ذاتها، انسداد الأفق الاقتصادي، أزمة الثقة في المؤسسات، والرغبة في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. وإذا كان جيل “زيد” في نيبال قد أظهر قدرة على الحشد والتأثير، فإن نظراءه في المغرب يحاولون اليوم استلهام التجربة، لكن ضمن سياق سياسي وأمني أكثر صعوبة.
النقاشات المتداولة داخل المجموعة التي تم إنشاؤها على تطبيق “ديسكورد”، والتي يتجاوز عدد منخرطيها ثمانية آلاف، وتستضيف شخصيات للنقاش معها مثل الصحافي عمر الراضي والأستاذ الجامعي رشيد العشعاشي وغيرهم، تكشف عن جيل جديد يسعى إلى بلورة خطاب احتجاجي مختلف، يمزج بين الحماس الرقمي ومحاولة التنظيم الواقعي.
اللافت في هذه المبادرة هو تأكيد أعضائها في كل مناسبة على استقلاليتهم عن الأحزاب، النقابات، والتيارات التقليدية، وهو ما يعكس نفور جيل كامل من الأطر الوسيطة التي فقدت مصداقيتها. إذ يؤكدون أن مطالبهم تمثل هموم الشعب اليومية، من الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق، إلى العدالة الاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد.
المنشورات تكرر ضرورة التمسك بالسلمية والحفاظ على الانضباط، لأنه في اعتقادهم يمكن أن يجنبهم القمع والاعتقالات والاتهامات بالانفصال والعلاقات مع جهات خارجية، إذ يحاول الشباب من خلال ذلك بناء شرعية أخلاقية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. غير أن التمسك المطلق بالسلمية قد يصطدم بواقع التعامل الأمني الصارم للدولة، خصوصا وأن السلطة دأبت على مواجهة الحركات الاحتجاجية بالمقاربة الأمنية رغم سلميتها.
بالعودة إلى المطالب المرفوعة والمتمركزة في التعليم والصحة ومحاربة الفساد واستقلال القضاء، تبدو هذه المطالب فضفاضة وغير واضحة، إذ يبدو أن هناك ضعفًا لدى المنظمين في بلورة ملف مطلبي دقيق وواضح، وهو ما يضعف قابلية التحقيق والضغط والاستمرارية. فالقوة الأساسية لأي حركة اجتماعية غالبًا ما تكمن في وضوح المطالب وقابليتها للتنفيذ. هذا التشتت قد يؤدي إلى تفكك، خصوصًا وأنه من خلال متابعة النقاشات يبدو أن هناك فقدانًا للثقة الداخلية بين أصحاب المبادرة والمنخرطين فيها، وهو ما قد يضعف القدرة على خلق جبهة شبابية موحدة.
إضافة إلى ما سبق، فإن غياب قيادة موحدة وتعدد الرؤى يزيد الوضع تعقيدًا؛ فهناك من يدعو إلى العصيان المدني، المقاطعة، والحق في المحاسبة الشعبية المباشرة، مقابل أصوات أخرى تدعو إلى تجنب إعلان أماكن المظاهرات مبكرًا أو الاكتفاء بتنظيم مظاهرات أمام البرلمان أو القنصليات. هذا التناقض يعكس غياب رؤية استراتيجية موحدة، ويطرح التساؤل: هل الهدف هو إصلاح النظام من الداخل أم إسقاط بنيته العميقة؟ أم أن هذه المبادرة هل فقط محاولة للتعبير عن الغضب وعدم الرضا عن سياسات الدولة التي تؤجج الاحتقان الاجتماعي.
إن هذه المبادرة، على الرغم من التساؤلات التي أثيرت حولها، قد أثارت فضول المتابعين للشأن العام المغربي. فحتى لو انتهت إلى الفشل، فإنها نجحت في شيء أساسي، لقد فتحت أعيننا على جيل كان مهمشًا ومنسيًا، جيل وصف لسنوات باللامبالاة والصمت، فإذا به يرفع صوته ويعلن حضوره.
إن مجرد خروج هذا الصوت إلى العلن، بكل ما يحمله من ترددات وتناقضات، يعيد طرح سؤال الأجيال والقدرة على التجدد داخل المجتمع المغربي. وربما تكمن قيمة المبادرة الحقيقية ليس في ما ستنجزه ميدانيًا فقط، بل في كونها كسرت صورة نمطية عن جيل كان “ميتا” سياسيًا، لتقول إن هناك حياة جديدة تنبض في عمق هذا الشباب.
وفي الختام، لا يمكن أن ننسى أن جيل “زيد” هو جيل العهد الجديد، جيل من نفس سن وثقافة ولي العهد؛ بخلاف الأجيال السابقة، يعتمد هذا الجيل على أدوات رقمية، ابتكارات سلمية، وأشكال تنظيم لامركزية أربكت وستربكُ السلطة، لأنه جيل خرج من رحم الإنترنت، لم يعش خوف وبطش “سنوات الجمر والرصاص”، ولا يكترث للقبضة الأمنية التي ضربها مغرب اليوم، بعد تجربة 20 فبراير وحراك الريف.
فالمخزن، الذي اعتاد على مواجهة احتجاجات تقليدية بقيادة نقابات أو أحزاب يسهل احتواؤها، يجد نفسه اليوم أمام جيل يصعب اختراقه أو ترويضه، لأنه لا يتحرك وفق منطق الهرمية الكلاسيكية، بل بمنطق الشبكة المفتوحة. هذا ما يجعل من حراك جيل “زد” تحديًا غير مسبوق للمخزن في العهد المقبل، إذ قد يكون المقياس الأول لقدرة الدولة على التكيف مع احتجاجات مبتكرة، تقودها فئة شابة لا تؤمن بالإحتكار والسلطوية.